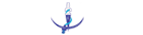قارورة

المرأه في الصحافه الأردنيه للحديث عن التجربه الصحفيه – المعهد الدولي لتضامن النساء – عمان – الأردن
مارس 22, 2002
مؤتمر الاعلاميات العربيات الثاني
أكتوبر 24, 2002بأي الفصول ارتبط الاجتياح؟
لا أعرف كيف وجدت نفسي أحتار في مثل هذا التساؤل.. فاجأني التساؤل بحد ذاته.. كيف جاءني؟ أظنني كنت أحاول تذكر الاجتياح السابق.. كان الجو حارا جدا، ومتعبا حد الملل.. ثم تذكرت اجتياحا قبله كان الطقس فيه شديد البرودة، وصوت الريح يختلط بضجة الآليات العسكرية.. ها أنا من جديد تتعبني محاولة ترتيب الصورة.. بأي شكل يأتي الاجتياح؟ كيف يكون لون السماء، رائحة الجو، درجة الحرارة، الرياح؟ كيف يمضى النهار؟ والليل؟ ماذا أفعل أنا عندما يجتاحون؟ما الكتب التي أقرؤها؟ ما الأفلام التي أشاهدها؟ ما نوع الموسيقى والطعام الذي أفضله؟ ….. كل هذا ليس مهما.. المهم هي الجامعة، إلى متى سنبقى في البيت والجامعة مُعطََلَة؟ إلى متى سيتأجل تخريجي؟ ..
الصيف أيضا مهم.. هل سنتمكن من السباحة إن ظلوا هنا؟ أنتظر الصيف بفارغ الصبر، لا يعقل إن يمضي هكذا، دون تخرّج ولا سباحة… ربما أستطيع استغلال الوقت في القراءة، المرة السابقة أعدت قراءة “الضوء الأزرق”، وقبلها “طاغور” و”محمود درويش”، والمرة أشعر بالرغبة في إعادة قراءة “شكسبير” (هاملت، عطيل….).. لم أنتبه إلا الآن أني في الاجتياح أعيد القراءة… ماذا لو اجتاحوا طويلا، هل سيبقى لدي ما أعيد قراءته؟..
أشعر بالتعب.. الغريب أني أكتشف هذا اكتشافا.. أغفو قليلا أمام التلفاز وحين أصحو يكون مراسل إحدى الفضائيات العربية يقول ما معناه أن هذا الاجتياح قد يستمر ستة أشهر.. لم أصح بعد جيدا، لكني أذكر أني سمعت مثل هذا الكلام من قبل.. أكيد أنه جزء من مبالغة الصحافة للفت الانتباه.. وماذا لو لم يكن كذلك؟ ماذا لو كان هذا صحيحا.. أشعر فجأة بتوتر، بعصبية وغضب، هل سنسكت؟ هل سنقبل ذلك ونكتفي بانتظار انقضاء مدة العقوبة؟ أفكر، أنا بالذات، ألن أفعل شيئا؟ هل سأسمح لهم بتأخير تخرجي ستة أشهر؟ لا، سأخرج، سأتحداهم.. لكني لن أتخرج، ولن أسبح..
هكذا فجأة ينقلب مزاجي.. أشعر بالاختناق.. أرغب بالخروج قليلا، لكن بالخارج تمنع قوات الاحتلال التجول، والشمس شديدة الجفاف والحدة.. قد أخرج مساء.. فنحن هنا، في طرف المدينة؛ وراء خطوطهم الخلفية، يمكننا عدم الالتزام بمنعهم للتجول طالما آلياتهم ليست هنا…
أكره الاجتياح.. ممل حد التعب، وخانق.. في المرة الأولى كان مخيفا أيضا، لا بل كان مرعبا.. لا أذكر أني خفت في حياتي كلها كما خفت أثناء احتلالهم لرام الله في نيسان.. شعرت لأول مرة كم يمكن للموت أن يكون قريبا مني أنا.. أنا بالذات أشعر باستمرار أني لن أموت قريبا، اشعر باطمئنان غريب حيال ذلك.. لكنني في إحدى لحظات الخوف شعرت أني قد أكون فعلا على بعد خطوة من الموت.. شعرت أني أنهار، لا أريد أن أموت، لست جاهزة بعد لذلك.. لكنني لم ألبث وأن شعرت أني- إن كان لا بد لي أن أموت- لا يجب أن أموت هكذا، مهزومة.. ليس هكذا أحب أن تكون لحظاتي الأخيرة في دنيا الأحياء.. وفكرت في الذين أحبهم.. أنا متأكدة أنهم يعلمون كم أحببتهم حتى اللحظة الأخيرة، وسيشعرون بي حين أزورهم.. “ديمة، شو يعني؟ ما عشتِ ع الفاضي..”.. ولم أمت..
الاشتياق متعب أيضا.. في الاجتياح، يزداد اشتياقي.. وقلقي.. وتزداد أمنياتي.. في لحظات، أشعر بالاشتياق يخنقني.. وتتملكني الرغبة في البكاء.. أشعر بالحاجة لحماية كل ما أحب.. أدرك حجم التهديد، والعجز.. يستطيعون تدمير كل شيء وأنا هنا في البيت ممنوعة من التجول..
اليوم، لم أشعر بالخوف بعد.. كان الاجتياح “مسالما” جدا، لا إطلاق نار ولا تفجير ولا حتى سمعت صوت الدبابات.. كأنه يوم إجازة.. أنا وأبي معا طوال النهار، نمزح ونلعب ونتشاكس، ومن حين لآخر نراقب الحاجز الاسرائيلي على مشارف قرية سردا من شباك مطبخنا ونستغرب من وجود من يصرون على اجتيازه.. ثم نحضر الطعام ونتغدى وننام، كأنه يوم إجازة.. ثم أصحو على صوت المراسل- مراسل إحدى الفضائيات العربية-..
قارورة روحي تضيق أكثر فأكثر.. وروحي لا تفتأ ترتطم بالجدران وتدفع السدادة.. لا أعرف ما الذي أريده بالضبط..
أريد ألا تكون هناك اجتياحات، ولا احتلال.. أرغب أن أتفرغ للحياة.. أتمنى أن أنتبه أكثر لضوء القمر يتساقط على الكائنات، للناس من حولي يغضبون ويتصالحون؛ يحبون ويكرهون، للياسمين يصعد نحو تموز، للون البشرة يتفاعل مع الشمس……
أفكر لو يخرج المارد لي من إحدى القارورات المرمية هناك، سأطلب منه ألا يبقي منهم أحدا هنا.. وأن أنساهم .. لا بل أن ننساهم، وينسونا.. وسأطلب منه أن …. ماذا سأطلب منه أن يفعل بهم؟
لست أدري..
السبت..
ألا تتعب أحاديثنا من التعب؟
ها أنا أشرب القهوة، والشاي.. وأحضر الطعام.. وأرتب البيت.. وأتابع المسلسلات.. وأنام الظهر.. وأقرأ دون تركيز.. وألعب الشدة باستمتاع.. وأحتار ماذا أرتدي.. وأتخلص من الهواء الذي بداخلي باستمرار.. أتساءل، ما العلاقة بين هذا الهواء الذي أنفثه وروحي؟ ربما القارورة..
أخشى أني أتحجر..
تتعطل ساعتي البيولوجية.. كأني مخدرة، أفقد الشعور بالوقت.. أنام نهارا على غير عادتي، وقد أنام باكرا أيضا أو أسهر حتى الصباح.. ينعشني الفجر.. أهم بالنوم ثم أغير رأيي، هذا الفجر قد يساعدني على الأقل في الشعور بالحي في داخلي.. “لذيذ” هو الفجر رغم كل شيء.. كأنهم ليسوا هنا، تحتفي الكائنات بالنور.. ليتني كالكائنات.. أشعر كم أشبهها، في الفجر.. أقرر أن أشاركها طقوس الاحتفال علنا نتشابه أكثر، لكنني أتذكر أنهم سيسمحون لنا بالتجول بعد أربع ساعات وعلي أن أنام قليلا لأستفيد من حصتي في “التجول”..
“إلى أهالي رام الله، مسموح التجول من الآن وحتى الساعة الثانية .. إلى أهالي رام الله……”.. أشعر بالسخف وأنا أخطط لهذه الساعات الخمس.. أكرهها هذه اللعبة، لكنني لا أعرف كيف لا أشارك فيها.. فكرت قي مرة سابقة ألا أخرج حين يرفعون عنا حظر التجول.. هكذا سأكون قد تجاهلت لعبتهم كلها.. لكنني فكرت أني هكذا فقط سأفقد هذه الفرصة للخروج وسيكون علي الانتظار حتى يمنحوني الفرصة مرة أخرى.. سألعب لعبتي أنا داخل لعبتهم، لكني لن أخرج منها…
أين أذهب؟ الساعة الثانية عشرة سنتجمع على دوارالمنارة وسط مدينة رام الله لنعبر عن رفضنا للاحتلال.. طيب.. لا شيء قبل أو بعد.. أحب أن أمشي في الشارع الرئيسي أو شارع المكتبة لاستظل باشجاره، لكني لا أفضل أن أصطدم ثانية بمكبوتين -مثلي- لا يجدون غيري يفرغون كبتهم باتجاهه..
لا مكان لي أقصده خلال السويعات الخمس.. وربما خلال سويعات أطول قليلا ستكون ساعات رفع المنع في الأيام القادمة.. أخشى أني لم أعد أقدر على التجول، أنهم يخرجون إلى داخلي أكثر..اكتشفت أن الجو شديد الحر هذه الأيام.. هنا في الطابق الخامس من عمارة في منطقة الإرسال الجو ربيعي باستمرار.. تموز صار قريبا، الصيف هو الذي تأخر.. والكتابة لا تجيء..
احمل كاميرا الفيديو وأعيش مع أطفالي.. أطفال بحث التخرج الذي لا أعرف متى يجيء.. أشعر بالفرح وأنا أستمع إلى ما يقولونه لي.. كيف يشاكسون بإصرار حتى أنجح في ملامسة مساحاتهم الغضة.. فلا يستطيعون المقاومة ويتحدثون.. عن المسبح وعن الحليب والسيارة..
حمودة ابن العامين والنصف يحدثني عن أرنبه الذي يأكل الدجاج.. وعن فراشته التي تبكي..
– – هل تبكي الفراشة؟.. لماذا تبكي الفراشة، حمودة؟..
– – “كيف إحنا منعيط..”
يدهشني..
– – هل تبكي الفراشة مثلنا؟
– – “لأ.. آ..”
– – لماذا؟
– – “كيف إحنا منّام منعيط..”
حمودة تخيفه أصوات المفرقعات و”الطخّ”.. فينام في حضن والده.. يودعني قائلا “ما تتأخري” ويعدني أنا وعلي بـ”الشوكلاتة” و”المصاص”..
علي “البطل” ذو العامين يدعو باستمرار “قوم نضربهم بالعصاي.. قوم نضربهم بالحجر..”، يحلم بقيادة جرافة ويضحك عميقا لوعد “المصاص”.. أشعر أني أعرفهم منذ زمن..
ترى ماذا يفعلون الآن؟…
الأحد..
عندما يتقدم الليل يقل إحساسي بوجودهم.. غالبا ما أكون في البيت ليلا، لم يتغير الأمر كثيرا..
أنظر من النافذة فلا أرى أحدا.. اختفت السيارات التي توزع الموسيقى ليلا.. وأنا على السرير قرب النافذة يمنحني الهدوء مساحة أكبر للتأمل.. ليت لدينا ياسمينة.. ليت لدينا بحر..
عندما نتحرر، سأعيش قرب البحر.. أبي يفضل البقاء في رام الله.. فليكن، عندما نتحرر سيمكننا التنقل و السفر بحرية بين الجبل والبحر.. عليّ فقط أن أستغني عن “عزيزة” لصالح سيارة أَقدَر على قطع المسافات..
وسأزرع ياسمينة.. ياسمينة هنا وياسمينة هناك.. وسأحاول قدر الإمكان أن أشهد بداية الليل وآخره، على الشاطئ ومن الشباك، في الصيف والربيع وفي الشتاء والخريف….
ماما تقول أنهم رفعوا العلم الإسرائيلي على ما تبقى من مبنى “المقاطعة” ذلك المبنى القديم حيث مقر الرئاسة الفلسطينية.. لا أعرف لماذا أتذكر ذلك وأنا أحلم بالبحر..
أتخيله.. العلم.. كم أحبه، الأزرق.. وأحبه مع الأبيض.. ليتهم اختاروا لعلمهم ألوانا أخرى.. لم يحسنوا الاختيار، لا اختيار ألوانه ولا اختيار مكان رفعه.. هل يبقى العلم نظيفا حين يرفع على بقايا المباني المغبرة؟ .. ما الذي يشعر به من تبقى من سكان “المقاطعة” وهم يمرون من تحته؟ .. هو دائما حظي السعيد يجنبني مواقف كهذه.. فأنا لا أحب أن أراه هناك.. أتمنى أن يستمر هذا الحظ، ولا يقع نظري عليه بالصدفة حين أمر من هناك..
أحب أن أذهب لزيارة جدي حين يرفع منع التجول.. يسكن جدي مخيم قلنديا بين رام الله و القدس، هناك أيضا يعيش عمي وعائلته وعمتي وأبناؤها وعائلاتهم.. أشعر أني أشتاق إليهم.. في كل مرة أزورهم أشعر وأنا عائدة بالندم.. في البيت أشعر بالاشتياق إلى جدي، إلى سماع قصصه والحديث معه، لكنني حين أذهب أنشغل مع أبناء عمومتي وأطفالهم عنه..
جدي يعرف فلسطين حين كانت حقيقية.. يحكي عن تفاصيل “البلد” والحياة فيها بتفاعل فتي: فرح وحنق أو حيرة… تؤكد لي أن لجدي، هذا “الختيار” القوي قلب يتقن الدهشة… كيف كان جدي قبل خمسين عاما؟ أنجح في تخيله، لكن عبثا أحاول أن أربط بينه وبين الذي أعرفه.. ربما حين أتمكن من ذلك أتوصل إلى الشعور بأن فلسطيننا واحدة…
جدي “أبو علي” هو الوحيد الذي شعرت في صوته أن حيفا هي -دون جهد- جزء من فلسطين.. يحدثني عن عمله في رصف الطرق، شوارع كثيرة يتذكرها كلها.. يتذكر أسماءها وكم أتعبته…
ليتني مثله..
أتذكر شعور الغريبة الذي لم تخلصني منه زياراتي النادرة لأريحا ونابلس وبيت لحم وحيفا ويافا وعكا وزياراتي اليتيمة لجنين والخليل وطولكرم والناصرة.. حواسي الست تتيقظ، علني أنتبه لما بيني وبين هذه المدن “الفلسطينية”.. جدي لا يحتاج ذلك.. الرابط بديهي كاسمه “محمد علي” وحقيقي كسنواته الثمانية والعشرين هناك..
أحب أن أذهب لزيارته.. لكن الطريق صعبة، وأنا متعبة.. ومخيم قلنديا لا يقع في رام الله.. بل ويقع في الطريق إلى القدس..
أنا أعرف البلدة القديمة في القدس.. صغيرة، أزورها مع أمي واختي رهام صيفا كل ثلاث سنوات.. يتعبني المشي في أزقتها المبلطة.. لكنني أحبه.. وأحب الصعود إلى السور.. وشراء الهدايا لأصدقاء جزائريين أحدثهم بفخر حين أعود.. وأنتظر الصيف الثالث لأختبر مقدار المسافة التي قطعتها بيننا، وأتأكد أني كبرت.. أشتاق إليها كثيرا.. القدس مختلفة.. وكذلك غزة.. ورام الله..في كل منها ما أمتزج معه.. وفي غزة بحر..
لا أذكر منها سواه وشارعا واسعا تحيطه الأشجار، يشبه شوارع طفولتي.. وأغنيات العودة..
لكنها تمنحني أحلاما كثيرة.. وأكتفي.. فأنا أشعر الآن، وبعد ثمان سنوات أني صرت أعرف من أين “أدخل الى رام الله”.. أحبها كثيرا بعيدا عن الأطراف حيث الحواجز.. لكنها تفاجئني حين تستضيف الجنود..
الاثنين..
عندنا في آخر الإرسال، لا يأتي الجنود الاسرائيليون إلا قليلا.. وحين يأتوا، يمروا بالمكان ومن فيه بهدوء يضايقني..
يمر الجيب العسكري بنا ونحن نتمشى فلا يتوقف، ونحن -نترقب، ثم- لا نتوقف.. والتجول ممنوع..
لا أحب أن أعتاد عليهم.. أتخيل باستمرار أن في كل من هذه الآليات المغلقة جنود بأعين باردة مدببة لم تعد امتدادا لشيء.. أتذكر ذلك الذي كاد يضربني، في بيتنا.. أذهلتني عيناه حين اقترب كثيرا؛ غاضبا؛ رافعا يده؛ صارخا؛ في بيتنا..
أحب أن أتخيل أعينهم حين أرى سيارة عسكرية أو مجنزرة او دبابة.. هؤلاء يأتون إلى هنا.. دون أن يفكروا إن كنت أحب الخروج بالسيارة ليلا أو أفضل البقاء في البيت فيمنعون التجول..
في المساء يمتلئ شارعنا.. يخرج السكان للمشي في مجموعات، ويجددون هواءهم.. فهواء البيوت هو هو لم يتغير، ينفثونه ثم يستنشقونه حتى الملل.. ويلعبون كرة القدم، فالمونديال ما زال حدثا يجتمعون على أهميته.. ويشترون البوظة؛ والفلافل فقد أرسى أحدهم -أول أمس- مشروع “بسطة فلافل” تلاقي إقبالا شديدا..
أنا وأبي خرجنا أيضا..
أحب اللحظات التي نتشاركها .. تثيرني مقدرته على الحفاظ على روحه فتية، ومثابرته حتى حين يدفع كل شيء إلى عكس ذلك..
رغم “الطِّوَش” وعصبيته وعندي أنا.. يسعدني جدا قضاء الوقت معه.. ندلل بعضنا؛ نتناقش؛ نمزح كثيرا؛ ونلعب.. أو نجلس في “الفرندة” -مكانه المفضل-؛ يحكي لي، وأحب الاستماع إلى ما يحكيه..
أنا وأبي كنا نخرج لنتمشى قبل سنين، قبل أن يشغلني العمل والدراسة معا.. كانت المنطقة أوسع، قبل أن يملأها البناء وسكان يخنقهم منع التجول.. أبحث أحيانا عن تلك البقعة التي كانت تفيض خضرة في الربيع.. لا أجدها دائما..
أبي سينتقل للسكن في الرام، ما بعد الحاجز العسكري الاسرائيلي الاول في الطريق الى القدس..
أكاد أبكي..
يبدو أن رام الله لم تعد مكانا يصلح للعمل، وها هي المؤسسة حيث يعمل تغلق مكتب رام الله -مؤقتا-وتفتح مكتبا في الرام؛ وينتقل الموظفون للعيش قرب المكتب الجديد.. إلى حين..
أختنق..
أفكر ماذا سيحمل أبي معه إلى هناك.. أنظر إلى أشيائه، وأهم بسؤاله ثم أتراجع..
لا أتخيل أني سأصحو وأذهب إلى الجامعة – وبعد شهر أو اثنين إلى العمل- دون أن أقبله.. ثم حين أعود في المساء أحدثه وأسمع أخباره بانتظار أن أراه في آخر الأسبوع.. على بعد كيلومترات قليلة تفصل بيننا ستة أيام كاملة.. لا أتخيل كيف ستكون أمورنا.. وأحبس دموعي.. لا يمكنني فعل شيء، حتى أنني لا أعرف ماذا أتمنى.. فهو سيذهب بعد يومين..