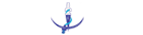رئـــة ثـــالــثـــة

مسقط: مسابقة عمان الدولية الأولى للتصوير الضوئي تكرم الفائزين
سبتمبر 29, 2016Howto fix your startup drive is nearly entire problem in Mac
سبتمبر 30, 2016يعقوب الخنبشي * – جريدة الرأي
يقول «دوستويفسكي»: عن أي شيٍء يمكن لامرئٍ شريفٍ أنْ يتحدثَ بمتعةٍ كبيرةٍ؟ الجوابُ: عنْ نفسه.
ورغمَ أنني أُخالفُ هذا الرأيَ، إلا أنني سأتحدثُ هنا عن نفسي!
يسألونك عن القلم، قل القلم أداة لانتشالِ الكاتب من عوالمهِ ليُخرجَ من دمهِ ما يطيرُ به نحوَ العلاقةِ الشائكةِ بينَ الذاتِ الكاتبة ومفرداتِ الحياة.
ربما لم أحلمُ في طفولتي بكتابٍ ولم أشترِ كتاباً وأنا طفلٌ لأنه لم يكن لدينا مكتبة ولا يُوجد في قريتنا من يبيعُ الكتبَ رغم وجودها على «روازن» منزلنا ومنازلِ بعضِ بيوتِ أصحابِ الجاه
والمال، فعُمانُ التي مرت عليها فترةٌ عصيبةٌ عزلَتها في تلك الفترة عن العالم، حُرِمَ أبناؤها حينها من أمورٍ كثيرةٍ بما فيها التعليمُ النظامي.
ورغم تلك الممرات الضيقة التي وقفتْ في وجه طموحاتِ الحياة إلا أنَّ الانسانَ بطبعه يخلقُ ويستشرفُ نورَ الأملِ من أقلّ الأشياء. فحينها كانت مدارس الكتاتيب تنثر نورها وتزرعُ على مرتاديها وفي أرواحهم العطشى شُعاعَ العلمِ.
من ذلك المكانِ كما أراهُ الآنَ، ومن تلكَ المدرسةِ الصغيرةِ الواقعةِ في قلب مدينة «الرستاق» وداخل قلعتها العظيمة، ما زلت أتذكرُ أولَ حرفٍ رسمتُه بيدي، كان ذلكَ على لوحٍ أسود صغير، اشتراه لي أبي من السوق مع مجموعة طباشير مصنوعة من مادة الجير محليةَ الصنع، وألحقني بمدرسةِ القرآن قبلَ سنّ الدراسةِ المتعارف عليه آنذاك.
لقد كان حرفُ «ب» خصميَ الأولَ، فعندما وصلتُ إلى مدرسة القرآن متأخراً، كان أقراني قد تجاوزوني في دراستهم حرفَ «أ» إلى غيره من الحروف، ولم ينتبه معلمي إبراهيم لذلك الحضور المتأخر والمفاجئ فانهال عليّ بخيزرانته اللاسعةِ على ظهري، دونَ أنْ يسألَ عن سببِ خلوّ لوحي من عدد من الحروف.
على كلّ حالٍ، تجاوزتُ الموقفُ وكذلك محنةَ الكتابة، وتفوقتُ على أقراني الذين سبقوني في ذلك الوقت، ولكنني لم أحلمْ يوماً أنْ أكونَ كاتباً ولا أعرفُ كيفَ حدثَ ذلك! كل ما أتذكره كان مجردَ حُلمِ لا أكثر! كنتُ كلما شاهدتُ كتاباً على رفّ أو منضدةٍ أو «مرفع» ما، أجدُ شيئاً خفياً يدفعني نحو الكتاب، ودون أيّ إرادةِ مني أنجذب بقوة المغناطيس وأنا في تلكَ اللحظةِ أشبهُ بطفلٍ مسحورٍ يمضي إلى قدرهِ دونَ درايةٍ لأغوصَ في أعماقِ ما تصلُ إليه أناملي من الكتبِ والمجلاتِ.
كنت لا أستطيعُ أنْ أكفَّ يدي عن ملامسةِ أغلفةِ الكتبِ، ورغمَ قساوةِ الضربِ والزجر في كثيرٍ من الأوقات، ما زالت عبارةُ «إجلس يا ولد، الكتب ما محطوطة حال لعب الصغيرين» (أي أن الكتب لم توضع ليلعب الصغار بها) باقيةً في الذاكرة.
وحين كانت خالتي تروي لنا قصصَ ألفَ ليلةٍ وليلة والحكايات العمانية مثل حكايات «كميّل العشرين» و»بنت السلطان» و»محيريق وأخته»، كنت أدوّن تلك الحكاياتِ الشعبية على دفتر أحمرٍ صغير، بأسلوبٍ غشيم دونَ تثقيفٍ وكما كانت خالتي تحكيها، لتمرَّ الأيامُ بعدها بسلامٍ وأنا أُدوّنُ خواطري على كشكولٍ آخرَ لتبقى حبيسةَ الأدراجِ والدواليب.
وحينَ أضاءتْ لنا الدنيا وفتحَ اللهُ على عُمان وتغيرتْ صيرورة الحياة وفُتحتِ المدارسُ كانَ هناكَ شيءٌ ما يجذبني نحوَ القلمِ والورقةِ وعبرَ مكتبةِ الراشدين بمدرسةِ الإمامِ ناصر بن مرشد الثانوية، حيث كانت ملاذي الآمنَ في الفترةِ المسائيةِ بعدَ الدراسةِ لأكسرَ ضجرَ الوقتِ ورتابة الأيام ولكونِ المدرسةَ تقعُ في الحيّ الذي أسكنه، حينها سخَّرَ لي الأستاذُ كمال لبيب، أمينُ المكتبةِ، معرفتَه وثقافتَه الواسعةَ عندما اكتشفَ شغفي وحُبي للكتبِ والمطالعة، فقدْ سمحَ لي باستعارةِ أكثر من كتابٍ في المرةِ الواحدة وكان يُرشدني إلى ما يُوافقُ ميولي ورغباتي من أصنافِ الأدب.
حدّانِ مرعبان اسمهما التديّنُ والكتابةُ تَصارعا داخلي، غلبَ التديّن لفترة ما وهو يطرقُ صوتَ المحرّم في أعماقي ليقولَ لي إنَّ منْ يكتبُ في غيرِ شرعِ الله ستأتي عليه كتاباته شاهدةً عليه يومَ القيامة، وحينَ عدتُ من بعثةِ الحجِ العُمانية التي شاركتُ بها، وذلك ضمنَ الوفدِ الكشفي وأنا طالبٌ في الإعدادية، وبعد تلك المحاضراتِ التي سمعتها تحتَ أسقفِ وأروقةِ المساجدِ، وحين انبرى أحدُ خطباءِ الجمعةِ ليسرّب إلى ذاكرتي محذراً من العواقبِ الوخيمةِ التي تنتظرُ «الحداثيين» ومصيرهم المؤلم الذي ينتظرهم من إضاعةِ وقتهم وعملهم فيما يغضبُ الله، أحرقتُ قصصي وكشكولي الأحمرَ وأشرطةَ الأغاني، وكلَّ ما كان سيقودني نحوَ التهلكة، ولزمتُ بابَ التديّنَ ولبستُ «مصريّ» الأبيضَ لأكتشفَ أنني محشورٌ في عتمةٍ مغلقةٍ لا أعرفُ نهايتها، لفتني الكوابيسُ داخلَ كفنها ولم تتركْ لي فكاكاً منها.
إلا أنَّ روحيَ ظلتْ تطاردني وتنزعني إلى شيءٍ ما لأبحثَ في ساعاتِ الخشوعِ عن الخواطرِ الإلهامية لتخرجَ من أصدافها القاسيةَ ويلوحُ لي ضوءٌ في نهاية النفق. فاندفعتُ إليه وأمامي تضاريس موحشة اجتزتُها بسلامٍ، وخرجتُ كالطفلِ الناجي من قاعِ البحرِ وعدتُ إلى طلاسمَ روحي، واسترجعتها إلى عالمِ القراءةِ والكتابةِ إلى حيث عالمهما الواسع.
أمطرتِ الحكايةُ بين أصابعي حينَ خرجَ عملي الأولُ متجسداً في روايتي «السفرُ آخر الليل» والتي كانت في بداياتها قصةٍ قصيرةٍ لأجدَ لاحقاً نفسي أعيدُ كتابتها. وجدت سطوةَ الحكايةِ ودهاليزَ الأحداثِ تنساقُ وتتلاحقُ، وتضاريسها تفيضُ لتخرجَ في نهايتها كما خرجتْ عليه سابقاً حيث صدرتْ الطبعةُ الأولى عن دار أزمنة (2007) ثم صدرت طبعة ثانية في العام 2015.
لا أخفي سراً حين أقول إنّ «السفر آخر الليل» كان أقرب القصص محبة إلى قلبي من بين أعمالي التي ظهرتْ حتى الآن، ليسير العمل بتفاصيله الصغيرة ويقترب بمرآته الفضية نحو الواقعيةِ التي أعشقها، حيثُ بطلُ الرواية (أحمد) الذي يعملُ فرّاشاً في إحدى الوزارات في مسقط، يصدمَ بواقعِ الحياة ومتاعبها ومتطلباتها، مما يدفعه إلى البحثِ عن الرزقِ و مضاعفةِ دخله عبرَ «التاكسي» الذي يمتلكه، نظراً لكونه العائلَ الوحيد لأسرته وراتبه الشهري لا يسدّ احتياجات أسرته، وتكاليف حياته في مسقط، ليتعرفَ في إحدى طلعاته الطويلة إلى «طاهرة» ابنةَ العشرين ربيعاً، والتي سيكون لها دورٌ مهمٌ في حياته، إذ تقلبها رأساً على عقب.
بين زمنَي طبعتي عملي الروائي الأول، جمعتُ خيمةَ حكاياتي لتخرجَ مجموعتي القصصيةُ «لذة ميتة» عن دار نينوى (2011)، واشتملت على ثلاثة عشر نصاً.
وها أنذا أحاولُ العودة مرة أخرى إلى الرواية التي أجدُ فيها ذاتي أكثرَ من القصة، حيثُ صدرتْ روايتي «عودة الثائر» (2016) دارِ الانتشار العربي، وهي رواية سياسية تاريخية تحكي قصةَ النضالِ، والكفاحِ، والثورةِ العمانية، من أجلِ حياة أفضل في زمن ساد فيه ظلمٍ وجبروت الجهل والتخلف في تلك الحقبة من الحياة التي عاشتها عمان، كما إنها تحتفل بالمكان والزمان في مدنٍ عربية عدة ابتداءً من الرستاق، ثم العودةَ إليها مروراً بكلٍّ من دبي والبحرين والدمام ودمشق وبغداد وبيروت وعدن وجبال ظفار، وتمثلَ هذا الاحتفاء عبرَ بطلها «خلفان سالم» الذي عاصرَ زمنَ إمامةِ عُمان وشهدَ تردّيها وتخلفَ فكرها السياسي، ومن ثَمَّ عهد السلطان سعيد بن تيمور حيث قاومَ الشعبُ العماني في ثورته الوجودَ الإنجليزي، لتمتدّ الأحداثُ حتى منتصفِ التسعينات من القرنِ الماضي.
حينَ أُسئل لماذا تكتبُ؟ لا أجِدُ رداً سوى القولِ إنَّ الكتابةَ -بالنسبة لي- رئةٌ ثالثةٌ أتنفسُ من خلالها، لا أبحثُ من خلالها عن مجدٍ أو شهرةٍ ولا أسعى من أجلِ جائزةٍ أو منصبٍ، فكلّ ما لا أستطيع أن أقوله باللسان أكتبه على الورقِ ليبقى ما يبقى في ذاكرة الزنبقِ والريحانِ ويذهبُ ما يذهبُ إلى سلةِ المهملات وذاكرة النسيان.
* قاص وروائي عماني